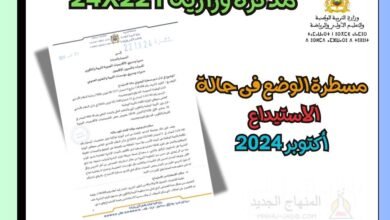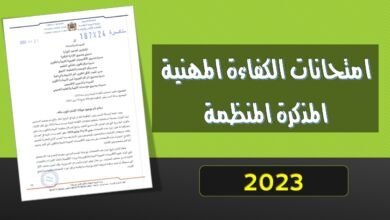ليست المدرسة في الوقت الحالي مجالاً لتحصيل العلم والمعرفة بحشو رؤوس المتعلمين بالمعارف فقط، بل هي مؤسسة تُعِدُّ التلاميذ عبر تربيتهم بشكل علمي، وعملية الإعداد هذه، ما هي إلا تأهيل. ولن تنجح المدرسة في وظيفتها إلا إذا كان التعليم فيها هادفاً لتأهيل المتعلمين لاتخاذ مهنة من المهن. ويأخذ علم النفس في ميدان التربية حجر الأساس في بناء جيل المستقبل بطرق بيداغوجية وعلمية، إذ يتمكن المُدرس المُلم بنظريات علم النفس من معرفة مراحل النمو وخصائصه عند الأطفال، وبهذه المعرفة، يتمكن من تنظيم مراحل التعليم وفقاً لهذه المراحل واقتراح المواد الدراسية المختلفة التي تتفق وكل مرحلة، كما تؤدي خبرته إلى مرافقة المتعلمين خلال مشوارهم الدراسي بكيفية علمية عبر فهم السلوك وتفسيره وفق آليات وخبرات أكاديمية تُتيح له إمكانية التبنؤ بالسلوكات المنحرفة مستقبلا عبر سيرورو التعليم والتعلم.
إن ما يجعل من المُدرس مُدرسا ناجحا ليس امتحانات الكفاءة المهنية التي تتدخل فيها جهات نافدة تُجهز على عدد المقاعد المخصصة لهذه العملية القيسرية، بل تُقاس الكفاءة بمدى معرفة المعلم للفروقات الفردية للمتعلمين وإدراك قُدراتهم والكشف عن استعداداتهم وميولاتهم وسمات شخصياتهم، حيث تُساعده هذه الأمور مُجتمعة في ابتكار أحدث الطرق التي تُقاس بها هذه الفروق وبالتالي وضع تخطيط يلائم حاجيات المتعلمين، وتوجيه التلاميذ إلى المواد الدراسية والمجالات المهنية التي تتفق وهذه القُدرات والإستعدادات التي تُميزُ سمات الشخصيات.
ولما كان للتلاميذ مشاكلهم الخاصة الاجتماعية والنفسية، فعلى المُدرس أن يُهيء الظروف الملائمة لهم للتغلب على مثل هذه المشاكل وتقديم خدمات تربوية علمية تمتح من نظريات علم النفس لمعالجة كل مشكل على حدة، طالما أن كل طفل هو حالة نفسية فريدة تختلف كل الاختلاف عن باقي الأطفال.
يقوم علم النفس على الطريقة العلمية ومحاولة التوصل إلى القوانين العامة المفسرة للسلوك البشري والطفل بشكل خاص داخل المؤسسات التعليمية. وذلك من خلال دراسة الحالات التي تثير الملاحظة عبر اكتشاف السلوكات المنحرفة ودراستها علميا للتدقيق في تفسيرها وفهمها فهما معقولا يعطي التنبؤ كثمرة بمشكلات المستقبل من السلوكات.
وتسعى كل العلوم وبكل فروعها وتخصصاتها إلى حل المشاكل كيفما كانت طبيعتها، ويسعى علم النفس التربوي والتحليلي إلى اكتشاف وتحليل وتبويب المعلومات للتنبؤ عن الظواهر التي يَدْرُسها، للإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية وهي:
- 1. ما طبيعة سلوك الطفل ؟
- 2. كيف يُنتج الطفل سلوكاته؟
- 3. لماذا يَسْلُكُ الطفل هذه الطرق لانتاج سلوكاته التي يُبلورها في إطال أفعال؟ ما طبيعة هذه الأفعال؟ هل هي تدخل في إطار التعزيز أم الرفض؟
يشكل النمو النفسي مجموع التغيرات الجسمية والفسيولوجية التي تطرأ على الأطفال من حيث الطول والوزن والحجم والتغيرات العقلية المعرفية والوجدانية، ثم التغيرات السلوكية الإنفعالية والاجتماعية التي يمر بها الفرد في مراحل نموه المختلفة. لذلك، سنحاول الإجابة على الأسئلة التي طرحناها في الجزء الأول من مقالنا، بحيث نذكر بالسؤال الأول كمايلي:
ما طبيعة سلوك الطفل؟ وكيف يُنتج الطفل سلوكاته؟
لماذا يَسْلُكُ الطفل هذه الطرق لانتاج سلوكاته التي يُبلورها في إطار أفعال؟ ما طبيعة هذه الأفعال؟ هل هي تدخل في إطار التعزيز أم الرفض؟
للإجابة على السؤالين الأول والثاني يتطلب الأمر منّا وصفاً دقيقاً وواقعياً لما يقوم به الطفل أي؛ وصف سلوكه من خلال أفعاله. والإجابة على السؤال الثالث تتطلب البحث عن الظروف التي تعتبر مقدمات سبقت السلوك ورافقته ويؤدي فهم السلوك إلى التنبؤ به مسقبلاً وبالتالي التحكم فيه. فإذا تمكنا مثلاً من معرفة السلوكات المنحرفة، وعرفنا أن بعض الأطفال الصغار ما بين سن السابعة والثامنة عشرة ينحرفون كثيراً مما يُوقعهم في مشاكل مع محيطهم ( المجتمع )، واكتشافنا لماذا ينحرف هؤلاء الأطفال، فإنه يمكننا التنبؤ بالسلوكات المنحرفة في الفرد عموما بشكل دقيق وعلمي. وبالتالي أمكننا التحكم في طبيعة السلوك الذي ينتجه الأطفال والتحكم فيه باتخاذ مراحل وخطوات للوقاية والعلاج، عبر خلايا التتبع والإنصات داخل المؤسسات التعليمية المنوطة بتقديم السلوك المرغوب وتعزيزه ودحض السلوك المرفوض وتقويمه بآليات التصحيح والمواكبة.
وتقوم دراسة سلوك الطفل في مراحل نموه المتتابعة على نتائج البحوث العلمية القائمة والتجارب العيادية والإكلينيكية الخاضعة لكل ما هو علمي بالأساس. وتتناول أغلب البحوث في علم النفس، دراسة سلوك الأطفال ونموهم الطبيعي في إطار العوامل الوراثية والعضوية التي تؤثر فيهم. كما تستحضر هذه الدراسة النفسية العلمية العوامل البيئية كمحيط عيش الأطفال؛ أو ما نسميه المحيط السوسيو ثقافي للأفراد، دون إغفال دراسة أساليب وأشكال التوافق الاجتماعي والإنفعالي والعوامل المؤثرة في هذا التوافق.
إن إنتاج أنماط مختلفة من السلوكات لدى الأطفال يُعزى بالأساس إلى النضج على مستوى العمليات العقلية والوجدانية، وقد تحدث عالم النفس السويسري جان بياجي بهذا الخصوص عن المرحلة ما قبل عملياتية وما بعد عملياتية، حيث يتمكن الطفل من توسيع إدراكاته تبعا للمحيط والأفراد الذين يشكلون مجال القرب بالنسبة للطفل وطبيعة تكوينهم ومستواهم المعرفي. نحن نعلم كمدرسين بأن التعلم هو التغيير الذي يطرأ في السلوك نتيجة للخبرة والممارسة، ويتعلم الأطفال بشكل مُستمر الجديد من أنماط السلوك كلما وجدوا المُدرس الذي يهتم بفضولهم المعرفي ويضعه على مشرحة التحليل والقياس عبر آليات التفسير والفهم من خلال الإقتراب من وجدانهم وطرد الغرابة من جنبات الصف وتعويضها بالألفة حتى يعتاد الأطفال ويستأنسون بمعلمهم أولاً وبالمحيط الذي يضمهم.
وتتضمن العملية التعليمية التعلمية التركيز على النشاط العقلي الذي يُمارس فيه الطفل نوعاً من النشاط من أجل اكتساب خبرات في شكل قُدرات قابلة إلى أن تُصرَّف إلى مهارات لمواجهة جمهور أو عائلة من المُشكلات تمكن الطفل من الاعتماد على ذاته وتمرنه على تكوين شخصيته بشكل تتحدد معالم بناء الوعي بالذات وبالمحيط لتحقيق التخارج ( Extériorisation). وهو الأمر الذي طرحه وتحدث عنه الكثير من فلاسفة الوعي أكان هذا الوعي فلسفيا أم نشاطا عقليا مشروطا فيزيولوجيا أم تيارا حيوياً كما هو الحال عند هنري برغسون.
ويتفاعل كل من النضج والتعليم ويؤثران معاً في عملية النمو، فلا نمو بلا نضج ولا نمو بلا تعلم. وخير مثال على ذلك، فعل الكلام عند الطفل، فهذا الأخير لا يستطيع أن يتكلم إلا إذا نضج جهازه الكلامي وإلا إذا تعلم الكلام من أقرانه ومحيطه.
يصبح الطفل أكثر وعيا باستقلاله الجسدي وأقلُّ حاجة للوجود بالقرب من أمه في مراحل نموه الأولى قبل ولوجه المدرسة. وبعد أن يلج المدرسة يشرع في تلقي المعارف ممزوحة بأساليب تربوية تمكنه من أخذ السلوك المدني الذي يقذف به عبر مراحل التدرج الدراسي نحو تحمل المسؤولية، لذلك يعتبر المعلم خلال عملية التدريس القائد الأول لسفينة الدرس حتى يرسو بها في شطآن الأمان.
لا سبيل لخلق جيل متعلم ومُتشرب لأسس التربية إلا عبر التمكن المعرفي لأساليب التربية عبر استدماج نُظمها في سيرورات العملية التعليمية التعلمية بطرق تمتح من مختلف حقول وفروع علم النفس ومدارسه المختلفة وفق منهجيات مُعاصرة يكون فيها المدرس والتلميذ طرفان أساسيان والمعرفة تكمل المثلث الديداكتيكي بأبعاده الأساسية ليبلغ التعلم مداه الأقصى.
يشكل النمو الجسدي والعقلي والوجداني السمات الأساسية لتغير السلوك عند الطفل خصوصا في مرحلة المراهقة، إذ تُعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل التي يمر بها الأطفال، ونعني بالخطر ها هنا، كيفية تدبير المواقف إزاء إصدار الفعل والفعل المضاد له، حيث يعيش المراهق لحظات البحث عن الذات من خلال اتخاذ النموذج وفق الصورة التي ارتُسمت لديه عبر التربية، سواء تعلق الأمر بما تلقاه داخل الأسرة أم من وسائط الاتصال والعالم الرقمي أم من المدرسة باعتبارها بيته التنشئوي الثاني، لأن البحث عن الذات هو ما يُميزٌ مرحلة المراهقة. لذلك وغيره، نطرح مجموعة من التساؤلات علّها تُسعفنا في رسم معالم التفكير في مرحلة تُعد من أصعب المراحل ويتعلق الأمر بمرحلة المراهقة كما يلي:
ماهي أهم السمات التي تُميزُ مرحلة المراهقة؟
وماهي الطرق التي ينبغي اتباعها لقيادة المراهق تربويا كي لا يلج عالم الإنحراف السلوكي؟
تختلف المراهقة من بلد لآخر ومن ثقافة لأخرى، ذلك أن للمحددات السوسيومجالية دور كبير في تحديد معالم هذه المرحلة من مراحل نمو الأطفال، فالمناطق التي تعرف طقساً حاراً من حيث درجة الحرارة يصل فيه الأطفال إلى سن البلوغ بشكل مُبكر والعكس صحيح في البلدان التي تعرف انخفاضا في درجات الحرارة. وبما أننا نعيش في بلد يعرف مناخا متوسطا على غرار دول شمال إفريقيا، فمعدل سن البلوغ بهذه المناطق هو الرابعة عشرة، حيث يعرف جسم المراهق تغيرات كثيرة خلال هذا المرحلة، كالإزدياد في الوزن وطول القامة وتغير في الصوت وظهور الشعر في العانة والإبطين، ثم الوجه بالنسبة للذكور وبروز الثديين بالنسبة للإناث وبالتالي تسجيل نضوج على مستوى الإخصاب.
وتعرف مرحلة المراهقة بالنسبة للجنسين الذكور والإنات الظهور بمظهر البطولية وعدم الإدعان للرأي الآخر، ذلك أن هذا الأمر يُمثل بالنسبة للمراهق انهزاما. أما على المستوى التربوي يبحث كل من الجنسين عن النموذج المثالي الذي يُمثل بالنسبة إليهما الشخص المناسب والشخصية المرغوب فيها. لذلك وجب على من يسهر على تدريس وتربية هذه الفئة العمرية أن يوظف الطرق التربوية والبيداغوجية الملائمة التي تكشف عن تفتيق المواهب وتحويل السلوكات المنحرفة إلى كل أشكال الإبداع بدل كبح الطاقات الدفينة، بل العكس من ذلك تحويلها إلى أفعال تكتسي قيمة أخلاقية سامية ومقبولة اجتماعيا داخل النسيج التربوي والاجتماعي.
لا سبيل إلى ترسيخ السلوك المدني وإكساب المراهق الآليات القيمنة بأن تجعله يندمج بشكل صحيح في المجتمع إلا الطرق الفعالة في التربية، وخير مثال يمكننا أن نسوقه في هذا المقال، هو العمل في فريق تربوي منسجم يعمل على تفعيل أدوار الحياة المدرسية من خلال الأنشطة الموازية عبر الإشتغال داخل نوادي المؤسسة، كتشجيع القراءة وجعلها سلوكاً مرغوباً لدى الجميع وبلورة ذلك وفق أعمال مسرحية تطرح قضايا تربوية ذات الإهتمام المشترك والراهني بالنسبة للمراهقين، بحيث يأخذ العمل المسرحي في الأمام المواضيع التي تجذب اهتمام المتعلمين وتعمل على صقل مواهبهم وتشذيبها لبلوغ الغايات والمرامي التي تُشكل مشروع المؤسسة، وكما نعلم بأن أي مشروع لا يسجل نجاحاً إلا من خلال نتائجه.
بهذا المعنى، يبلغ الفعل التربوي مقاصده وأهدافه المتوخاة بالرغم من العراقيل التي تواجهه، فالعزائم القوية والرغبات الجامحة والإرادة المنبثقة من عميق التفكير، كل هذه الأمور تجعل من المراهقين شعلة المستقبل في عالم يعرف وثيرة مُتسارعة من حيث الخلق والإبتكار. فالأمم التي بلغت قصب السبق ركزت على العلم والمعرفة والقيم، وبدون الإهتمام بهذه الأمور، لا مجال للحديث عن حضارة أساسها الثقافة وسواعدها الشباب.