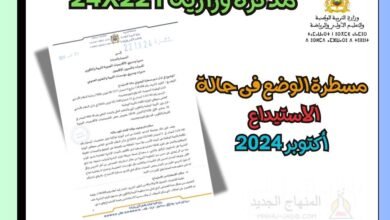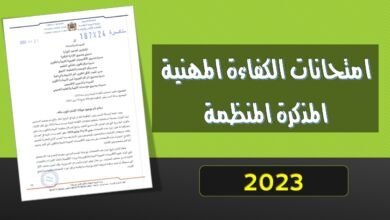لا يلبث الخطاب الرسمي المغربي إلَّا قليلاً حتى يعود إلى عَدّ قضية التعليم أو التربية والتكوين أولويَّة المرحلة، فقد أحصى المغاربة ما يزيد عن ثلاث محطات مفصليَّة خلال فترة حكم الملك محمد السادس تم فيها اعتماد المدرسة والجامعة المغربيتين مدخل الإصلاح الشامل. لكن للأسف الشديد يمكن تلخيص نتائجها بامتياز في المقولة الشهيرة “جعجعة ولا طحين”.
أحرصٌ هو أم العبث بعينه؟
خلال الفترة المذكورة نفسها، تتبع المهتمون التناقض الصارخ بين الوقائع والخطابات. في الإعلام الرسمي لا نسمع عن مسؤولينا إلَّا الخير والحمد لله، فالمغرب تجاوز عنق الزجاجة وخاض مشاريع الأوراش الكبرى للإصلاح، والمغرب خارج دائرة الدول المتضررة بالأزمة الاقتصاديَّة العالميَّة، والمغرب الدولة القوية في جنوب المتوسط وتحظى بالاحترام والتقدير من الولايات المتحدة، المغرب مُتقدِّم عن دول المنطقة من حيث الاستقرار وجلب الاستثمار الخارجي ورؤوس الأموال. هذا في الوقت الذي نرى فيه ونسمع التقارير الدوليَّة الصادمة، في المغرب لا تزال بؤرٌ للتوتر الاجتماعي في الشمال (بني بوعياش….) والجنوب (مخلفات أكديم أزيك وغيرها) والوسط (ثورة المعطلين نموذجاً)، وفي المغرب السجون تفتقر إلى تحقيق المعايير المطلوبة دولياً، ولا يزال في المغرب معتقلون سياسيون بالجملة، والحراك الاجتماعي في المغرب مرشح لأن يكون أقوى إن استمر الوضع على ما هو عليه، فالاعتقال على خلفية الانتماء السياسي لا يزال سياسة معتمدة في المغرب (الاعتقال الأخير لعمر محب)…. كما أنَّ التقارير الإقليميَّة والدوليَّة لا تتوقف عن تحذير المغرب من مخلفات اختياراته السياسيَّة والاجتماعيَّة من خلال تصنيفه في ذيل الترتيب الإقليمي والدولي ذي الصلة، متأخراً بذلك عن دول الحروب الأهلية و الأزمات الاقتصاديَّة، بل والاحتلال وقلة الموارد.
لنرجع إلى قضية التعليم نقاربها باختصار من خلال قضايا ثلاث نراها في نظرنا مفصليَّة.
قضية مدخل الإصلاح
لا نحتاج إلى خبرةٍ كبيرةٍ أو مراكز دراسات شهيرة حتى نقف عند إفلاس المنظومة، لأنه بمجرد وقوفك أمام مُؤسَّسة تربويَّة من مُؤسَّسات بلدنا الحبيب، أو من خلال مجالستك لأحد رجال التعليم أو نسائه والاستماع إلى خبر حال البيئة التعليميَّة، أو من خلال تتبعك لحوارات التلاميذ والطلاب حول أجواء التحصيل العلمي ببلدنا، يتكشَّفُ أمام عينيك حجم المأساة. الحقيقة أننا لم نعد أمام منظومة تعليميَّة بالنظر إلى الواقع المزري والمقاربات الضالة والشاردة التي تتبناها الدولة في حق هذا الورش الاستراتيجي. فكيف يعقل أن تقارب الدولة التعليم مقاربة مقاولاتية أساسها الربح المادي وما ينفق وما يجلب بعيداً عن أهداف سامية أصبحت في حكم الواقع نكرة، من منا قرأ أو سمع في مشاريعنا الوطنية “للإصلاح” كلمة “الواجب العلمي أو المعرفي” أو غيرها من المفاهيم الأصيلة في مرجعيَّة أمة “اقرأ”، متى كانت المدرسة أو المُؤسَّسة التعليميَّة جحيم المُعلِّم والمُتعلِّم ومتى ومتى من مظاهر اللا علم واللا تربية.
إنَّ ديننا الحنيف هو الوحيد الذي ارتقى بالعلم من مستوى القيمة إلى درجة الفريضة، فهل استطاعت الإصلاحات المتوالية أن تعدُّه كذلك. إنَّ ديننا هو الوحيد الذي شرَّع الإكراه لإشاعة العلم وشرع معاقبة كل من الجاهل الذي لا يريد أن يتعلَّم، والعالم الذي لا يريد أن يُعلِّم (واقرأ في الباب إن شئت حديث المُعلِّم الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هم أن يدمر الديار على الجهال المتهربين من العلم والعلماء المتقاعسين عن التعليم).
لا مدخل غير عَدّ التعليم قضية الأمة لا قضية السياسة والمزادات، لأنَّ الواقع يثبت أنه عندما كان أجدادنا يقطعون المسافات على الرغم من معاناتهم آلام الجوع والعطش لطلب العلم والقرآن (التخناش نموذجاً) كان وازعهم العلم الذي يرفع صاحبه درجات (اقرأ وارق). و لم يكن الوازع آنذاك لجان مراقبةٍ أو “خطاً أخضر” يرصد العورات و يزيد الأحقاد بين مُكوَّنات وأطر المنظومة التربويَّة. فلا سبيل لكسب الرهان إذاً إلَّا بانطلاقة واحدة صحيحة لا أكثر، وهي أن تمنح الدولة نفسها مسافة عن ضغوط المُنظَّمات الدوليَّة المانحة التي تريد مصالحها ولا تريد التقدُّم لأحد، فكفانا ذلَّا أن نعتبر تعليمنا الجامعي ناجحاً بتخريج قوافل من التقنيين الذين يتقنون إصلاح الحواسيب القادمة من عند الأسياد من وراء البحار وتركيبها، وكفانا مهانةً أن تتحول المدرسة العموميَّة بمرافقها المقفلة و حجراتها الوسخة إلى حلبات مصارعة بين المُدرِّس والمُتعلِّم، نريد أن نصنع ما نشاء وبالاسم والتركيبة والكيفيَّة التي نشاء، نريد جامعة مبدعة متحررة يعيش فيها الطلاب حقيقة الإبداع وواقع الدعم والاحترام والتوجيه والتقدير، نريد مُؤسَّسات نظيفة نظافة العقول و الصفحات البيضاء التي تلجها. كفانا من المقاربات الأمنية والأسوار العالية والفرق الأمنية الخاصة، كفانا زخرفةً للمداخل وموائد وشعارات ومطبوعات ملونة تروج الكذب وتزوير الحقائق. نريد مدرسة عموميَّة يُعَدُّ فيها المُدرِّس والتلميذ والإطار التربوي نفسه مسؤولاً عن الجودة والتربية والتعليم والتأطير، نريد أن تتعامل الأطراف بوازع الواجب لا تحت طائل المراقبة.
قد يقول قائلٌ إِنَّ هذا كلامٌ طوباويٌّ مثاليٌّ، فلمثل هذا نقول: انظر حواليك وإليك، من تريد وترضى لتدريس ابنك أو بنتك، فهل هو صاحب الضمير أم البارع في نقل الأخبار وإذكاء النعرات والحريص على تنميَّة ثروته على حساب العلم والمُتعلِّمين. بالتأكيد سيكون اختيارنا واختيارك الأول بلا منازع، لذلك نقول إِنَّ مدخل الإصلاح هو تكاثف الجهود، و تحديد طبيعة المجتمع الذي نريد، أهو مجتمع العلم لشرفه وقدره وجلاله أم مجتمع البيع والشراء باسم المعرفة، وتحمل الشعب ممثلاً في الأسرة والمجتمع مسؤوليته في تحرير المنظومة من أسر الدولة وسجن التعليمات العابرة للقارات التي أصبحت وحياً يسبح بحمده الحاكمون ولا يرون إصلاحاً إلَّا في ظلالها ويعتقدون البعد عنها إخفاقاً مُسبَقاً ومحتماً.
قضية الشراكة
شيءٌ جميلٌ أن تستطيع الدولة الخروج من مركبها النفسي الذي كانت تَعُدُّ من خلاله أطراف العمليَّة التعليميَّة فرقاء، لكن لا يكفي أن تخاطبهم بالشركاء لطي الصفحة، لأنه لا معنى للشراكة مع الفردانيَّة في تحديد التوجهات العامة والبرامج والمناهج ثم المناداة على الأطراف للإشراف على عمليَّة التنزيل. الشريك الحقيقي شريك في كل أطوار العمليَّة من تحديد التصوُّرات وتقدير المواقف واعتماد المناهج وتخطيط البرامج واختيار الكفاءات.
بناءً على ما تقدم من حديث حول مدخل الإصلاح الحقيقي، يمكن الجزم بأنَّ الشراكة هي ضمانة وحصانة الإصلاح الاستراتيجي، لأن قضية التعليم في البلد لم تعد قضية إخفاق سياسة من السياسات، بل تداعياتها تجلت بالواضح سلباً في كل مناحي الحياة، فأية أخلاق ترتجى لناشئةٍ لا تعرف عن دينها إلَّا الفتات جراء سلخ البرامج من المقوم الإسلامي من خلال التخلي عن حصص القرآن الكريم وتعاليم الإسلام لصالح قضايا أخرى تحت طائلة الضغط الدولي ممثلاً في المُؤسَّسات المانحة. وأية أطرٍ مأمولة تلك المتخرجة تحت وطأة العقليَّة الأمنية والبوليسية. و أي انعكاس إيجابي ننتظر من تعليم يخرج الطاقات المهدرة اليائسة المقهورة المنكوبة في شوارع العاصمة من فرط تعنت الحكومات المتعاقبة.
ما يرجى من الشراكة الحقيقيَّة، انتزاع التعليم من أنياب السياسة والإدارة إلى فضاءات الحوار الشعبي. ما يريده المغاربة تعليم شعبي تنظيراً وتقريراً وإنجازاً، وهو الواجب الغائب عن تفكير الدولة وإراداتها نظراً لسجنها تحت رحمة التعليمات وانبطاحها أمام التجارب العالميَّة في صورها الحديثة والمبنية طبعاً وفق مقاربات وأرضيات ومنطلقات وعقليات تختلف كلياً عما هو الحال في بلدنا، بل يمكن أن تناقض في بعض منطلقاتها أصولنا وهويتنا ومنطلقاتنا. ومن غير المعقول تماماً أن يتكرَّس لدى الدولة وفي أذهان من تصفهم الدولة الآن بالشركاء لتنفي الصفة عن الباقي، أنهم لوحدهم المؤهلون لمقاربة المنظومة التربويَّة ببلدنا، فهي سياسة ممنهجة لتهييج الفرقة حتى بين الشركاء الحقيقيين المنتظرين وتحويل بعضهم إلى مخبرين عن البعض الآخر لدى الدولة.
مجمل القول في قضية الشراكة، إن المطلوب وبإلحاحٍ ليس الانفتاح على المهتمين كما تزعم الدولة، ولكن الحوار المفتوح في وجه الجميع، ومن غير وصايةٍ أو توجيه، وفتح (أوراشٍ) النقاش الشعبي بالمُؤسَّسات التعليميَّة والجامعات والتجمعات الشعبية للوقوف عند المشاكل الحقيقيَّة والاستماع للتجارب والاكتواء بلوعة من تعج بيوتهم بضحايا العمليَّة التعليميَّة الحاليَّة من خريجين عاطلين أو مُتعلِّمين يائسين أو منقطعين عن العلم و أهله ساخطين عليهما.
قضية الإنتاجيَّة
نعم نريد تعليماً منتجاً كما يريده الجميع، لكن عن أية إنتاجيَّةٍ نتحدَّث. تنبري أطر الدولة المُتخصِّصة في التربية والتكوين لتُوضِّح رؤيتها لمفهوم الإنتاجيَّة، حيث يتلخص المفهوم في نظرهم، ونظر الساسة طبعاً بتخريج “أطرٍ” قادرةٍ على الاندماج في سوق الشغل. هدفٌ مهمٌ ونبيل. لكن السؤال البديهي المطروح، ما هذه السوق التي يتوجب على المستثمر تخريج بضاعته وفقها. أستسمح عن استعمال كلمة “بضاعة” لكنني أراها المفهوم الأقرب إلى تسمية هذه الأطر المغلوبة على أمرها وفق ما تنظر به الدولة في مشاريعها “الإنتاجيَّة” للتعليم.
من يشنف مسامعنا الآن بكثرة الحديث عن صنفونية التعليم غير المنتج، نسأله سؤالاً بريئاً براءة هذه الأجيال التي جربت فيها المشاريع المستوردة المتتالية. إنَّ الإنتاج أيَاً كان نوعه فهو نتيجة عمليات منسقة تسميها العلوم المختصة ب”إدارة الإنتاج”، فهو (الإنتاج) بلا شك من جنس الإدارة الناتج عنها وسليل الإدارة التي نسل عنها. فأية إدارةٍ تم اعتمادها من قِبَلِ هؤلاء الساسة المتملصين من مسؤولياتهم عن حق العمليَّة التعليميَّة. فإذا لم يستطع المنتوج أن يكون في المستوى المطلوب، فإنَّ العيب ليس فيه بقدر ما هو في مجموع العمليات المعتمدة والوظائف التنفيذيَّة التي تسيِّر (الورش) بأكمله، فالمُتعلِّم المتخرج إذاً نتيجة حتمية لعمليَّة إداريَّة منسقة من تصميم وتخطيط الموارد وجدولة محكمة وترسيم النشاطات الإنتاجيَّة ومراقبة نشاطات الإنتاج، ولا ينتظر أن يكون الإنتاج مرضياً إذا تم إهمال كل هذه العمليات أو تم تسخيرها بكيفيَّة غير علميَّة وغير منسقة. من يزرع الريح يحصد العاصفة.
لنسلِّم بأنَّ العمليات الإداريَّة والتنفيذيَّة لإصلاح المنظومة قد تمت على النحو المطلوب، فكيف يعقل أن يتحكَّم الاستثمار ورأس المال العالمي والمستثمر الأجنبي وصاحب المقاولة والشركات العابرة للقارات في تطلعات شعبٍ ومقومات أمةٍ وطموحات عقولٍ متعطشةٍ إلى المعرفة والعلم. لقد خاب الأمل حقاً عندما أصبح مصير أجيالنا بين مطرقة المستثمر وسندان منظومة متهالكة.
إذا كانوا يريدون أطراً معجونة على هذه الشاكلة، فالأوْلى لهم أن يستوردوا كميَّات كافية من الأنظمة الحاسوبيَّة والرجال الآليين المبرمجين ويمنحوهم الجنسية المغربية إلى حين انتهاء مهامهم، ولا داعي إلى إهدار هذه الأموال الطائلة وفتح الصناديق دون رقابة بدعوى أولويَّة التعليم. كفى استهتاراً لأنه لا يعقل أن يعتمدوا هذه المناهج والبرامج في مُؤسَّسات التعليم الأولي و الثانوي ويتبرؤوا منها في الجامعة بدعوى أنها تخصصاتٍ مفتوحةٍ لا تستجيب لسوق الشغل. فمتى كان الناس يتعلَّمون القرآن ليتأهلوا به إلى سوق الشغل، ومتى كان الطلاب يتعلَّمون نظريَّة النسبية وزحزحة القارات والانفجار العظيم وأصول الفكر الإنساني وتداول الحضارات وغيرها من فروع العلم للبحث عن لقمة عيشٍ في سكرتارية مكتبٍ أو مُؤسَّسةٍ خاصة.
إنهم باختصار، يحتقرون هذه العقول ولا يريدون لها علماً ولا معرفةً ولا حتى خبراً عن ذلك. و إنما يريدون تدجين المُعلِّم والأستاذ وطالب العلم وحشره في سرب قومٍ اشتروا الدنيّة من الأسياد طائعين دون إكراه.
فما جدوى أولويَّة التعليم في غياب الإرادة؟